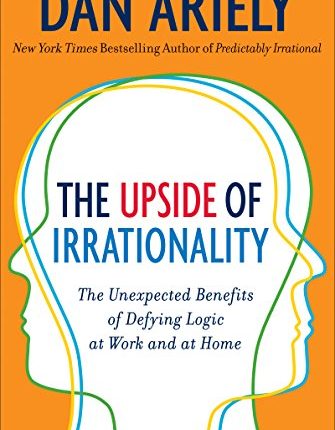الجانب الإيجابي من اللاعقلانية: الفوائد غير المتوقعة لتحدي المنطق في العمل والبيت
ملخص كتاب للاعقلانية وجوه أخرى !
– المؤلف : دان آرييلي
– عدد صفحات الكتاب : 350
– تاريخ النشر : 2010
– ملخص الكتاب ..
– كيف نتحدي المنطق في بيئة العمل .. ؟
منذ أكثر من قرن مضى، أجرى العالمان ”روبرت يركيز“ و”جون دودسون“ عدة تجارب في محاولة منهما لاكتشاف حقيقتين: أولهما مدى سرعة تعلم الفئران، والثانية حدة الصدمات الكهربائية التي تحفزها وتزيد سرعتها في الأداء والتعلم. جاءت بعض النتائج مماثلة لما توقعه الجميع، بينما جاء بعضها الآخر مخالفًا للتوقعات!
عندما كانت الصدمة ضعيفة، لم تحفز الفئران بما يكفي فانخفض مستوى الأداء. وعندما زادت شدة الصدمة، ارتفع مستوى التحفيز والأداء أيضًا. وحتى الآن لم تخرج النتائج عن المتوقع وفقًا للعلاقة المنطقية بين مقدار التحفيز ومستوى الأداء. ولكن حين
وصلت شدة الصدمة إلى ذروتها؛ تراجع مستوى الأداء بشكل غير معقول! يعتقد الإنسان عادة بوجود علاقة طردية بين قوة الحافز والقدرة على تحقيق مستوى أعلى من الأداء. فقد يبدو الأمر منطقيًا أنه كلما زاد تحفيزنا للقيام بأمر ما، بذلنا مزيدًا من الجهد لإنجازه، وبالطبع سيدفعنا هذا الجهد المضاعف خطوة أخرى نحو الأهداف المرجوة. امنح موظفيك مكافآت مالية ضخمة وستحصل على أعلى مستوى ممكن من الأداء! وربما يكون هذا المنطلق هو الدافع الرئيس وراء منح سماسرة الأوراق المالية والرؤساء التنفيذيين مكافآت خيالية! تدعونا هذه التجربة إلى التوقف لوهلة وتأمل حقيقة العلاقة بين المكافآت والتحفيز والأداء في سوق العمل، وسنجد التحفيز سلاحًا ذا حدين. فعلى الرغم من كونه أحد الدوافع القوية التي تحفزنا نحو مستويات أعلى من التعلم والأداء، إلا أن التحفيز قد يسبب ضغطًا شديدًا يعيق قدرتنا على التركيز وإتمام المهمات.
– جوهر العمل ..
نحن ندرك بالفطرة جوهر العلاقة بين هوية الإنسان وكينونته، وبين وظيفته وعمله. فالأطفال يحددون وظائفهم المستقبلية المحتملة منذ نعومة أظفارهم وفقًا لشخصياتهم وما يودون أن يكونوا عليه – سواء اختاروا وظائفهم كمعلمين أو أطباء أو رجال إطفاء – لا وفقًا للرواتب الشهرية! إذ تمثل الوظيفة جزءًا من هويتنا وشخصيتنا، لأنها ليست مجرد وسيلة لكسب العيش. لكن النموذج الاقتصادي في إدارة الأعمال – رغم وعيه بهذه العلاقة الوثيقة – ما زال يعامل الموظفين كما لو أنهم فئران في متاهة! ولهذا يتحول العمل إلى مهمات تثير الضجر حين تبحث الفئران عن قطعة الجبن – أو المال – بأقل جهد ممكن لكي تخلد أطول فترة ممكنة للراحة والهدوء. من ناحية أخرى، يعد ”تفتيت المهمات“ أحد أهم المخاطر التي تواجهها الأعمال القائمة على التكنولوجيا. حيث تتيح تكنولوجيا المعلومات تقسيم المهمات الكبرى إلى مهمات صغيرة ومنفصلة بحيث يصبح كل فرد مسؤولاً عن جزء صغير من المهمة الكبيرة، فتحرم الشركات موظفيها من رؤية الصورة كاملة ومن متعة الشعور بالإنجاز والنجاح المتكامل.
قد تجدي هذه الطريقة نفعًا لو كان الموظف إنسانًا آليًا! ولكن نظرًا لأهمية الدافع الداخلي كوقود للإنتاج والأداء العالي، فقد تأتي هذه الطريقة بنتائج عكسية. فمع انعدام الهدف والمعنى، يتحول الموظف إلى ”شارلي شابلن“ في فيلم ”مودرن تايمز“؛ يجري وسط تروس وعجلات الآلات في المصنع ويفقد الرغبة في تكريس كل طاقته وجهده في العمل.
إذا نظرنا إلى سوق العمل من هذا المنطلق، فسوف نرى الأساليب التي تتبعها الشركات والتي تقتل الحافز في موظفيها دون إدراك منها. فإذا ما أرادت الشركات حقًا أن تحصل على أعلى قدر من الإنتاجية، فلابد من غرس الإحساس بالقيمة لدى الموظفين من خلال تعزيز الشعور بالإنجاز والنجاح لديهم وتقدير العمل الجيد. وتؤثر هذه العوامل بدورها على الكفاءة والسعادة والشعور بالرضا في نهاية المطاف.
– لم نغالي في تقدير إنجازاتنا .. ؟
التفاخر بالذات والممتلكات من طبيعة البشر. فعندما تعد وجبة أو تصنع رفًا للكتب تبتسم والفخر يملأ عينيك قائلاً: ”كم أنا فخور بما أنجزت!“ فلماذا نشعر بالفخر في بعض المواقف، ولا نشعر به في أخرى .. ؟
أثبتت الدراسات أن الزيادة في المجهود تقابلها زيادة في التقييم في شتى المجالات. في إحدى التجارب القائمة على فن ”الأوريغامي“ الياباني، خصصنا حجرة في مبنى الطلاب في جامعة ”هارفارد“ وعرضنا على كل مشارك في التجربة أن يصمم طائر الكركي أو ضفدعًا أوريغاميًا. أخبرناهم بأن تصميماتهم ستصبح ملكًا لنا، ولكن سيمنح كل منهم فرصة للمزايدة على منتجه وشرائه في مزاد علني.
وسيكون الطرف الآخر في المزاد برنامج كمبيوتر؛ حيث ينطق الجهاز رقمًا عشوائيًا بعد أن يقول المتسابق رقمه أولاً. إذا زاد مبلغ المتسابق عما عرضه الكمبيوتر، يحصل الطالب على تصميمه ويدفع السعر الذي حدده الكمبيوتر. أما إذا كان أقل، فلن يأخذ تصميمه ولا يدفع قرشًا واحدًا. وقد وضعنا هذا الشرط لكي يعرف المتسابق أن عليه أن يعرض أكبر مبلغ يستطيع أن يدفعه مقابل منتجه.
كان الطالب ”سكوت“ من أوائل المتقدمين إلى المسابقة. فقد اتبع التعليمات بدقة واختار أن يكون منتجه الضفدع الأوريغامي. وعندما سُئل عن المبلغ الذي سيدفعه مقابل الضفدع قال بكل حسم ”خمسة وعشرون سنتًا“. بعد ذلك سألنا طالبًا محايدًا لم يشارك في التصميم: ”كم تدفع مقابل هذا الضفدع؟“ تفحص الطالب المنتج جيدًا ثم قال دون تردد ”خمسة سنتات“. فهناك فرق شاسع بين مقدار التقييم في الحالتين! فلم ير ”غير المبدع“ وهو الطالب الذي لم يصمم سوى كومة من الورق، أما المبدع ذاته، فقد أضفى على الورق قيمة إضافية من وجهة نظره. فالفرق بين الحالتين لا يكمن في كيفية رؤيتهما لفن الأوريغامي بشكل عام، وإنما في الطريقة التي أحب بها ”المبدع“ منتجه فبالغ في تقييمه.
– التخصيص والجهد والحب ..
مع بزوغ فجر صناعة السيارات، تهكم ”هنري فورد“ قائلاً إنه من حق أي عميل الحصول على السيارة التي يريدها طالما أنها سوداء! هذا لأن طلاء كل السيارات بلون موحد يعني انخفاض تكاليف التصنيع مما يعني زيادة المبيعات والأرباح. ولكننا نجد في هذه الأيام ملايين المنتجات التي تناسب كل الأذواق. فقد أتاح المصنعون الفرصة للعملاء كي يحصلوا على المنتج الذي يناسب أذواقهم، بفضل تطورات تقنيات الاتصال والأتمتة وخطوط الإنتاج.
بمقدورك الآن أن تختار طراز الحذاء الذي تود شراءه، والخامة التي يصنع منها واللون وهكذا. فلم يعد الأمر متعلقًا بالحصول على المنتج، بل باقتناء منتج خاص ومفصل على ذوقك ليناسب تطلعاتك.
لا يعني هذا بالضرورة أن تحول الشركات خطط إنتاجها بحيث يصبح العميل هو المسؤول عن تصميم وتصنيع منتجه. فثمة خيط رفيع بين التواكل أو الاستسهال، وبين الاستثمار. فإذا أردت أن تتخلص من عميلك ببساطة متناهية، فما عليك سوى أن تجعله يبذل مزيدًا من الجهد ليحصل على منتجك! فالجهد الذي تبذله أنت من جانبك يعني جهدًا أقل من جانب العميل، وعلاقة أقوى بينه وبين المنتج.
فالأمر برمته يتوقف على أهمية المهمة وعلى الجهد المبذول في تصنيع المنتج. وبمجرد أن تتوصل الشركات إلى إدراك المعنى الحقيقي للتخصيص أو ”التفصيل“، فستعمل جاهدة على تصنيع المنتجات التي تعبر عن تطلعات العميل قدر الإمكان وبالتالي تحقيق أكبر قدر من السعادة والمتعة له.
– هذا الحل هو الأفضل لأنه من بنات أفكاري ..
يمتد اهتمامنا وتقديرنا المبالغ فيه لإبداعاتنا ومنتجاتنا ليشمل الأفكار أيضًا. ولا يقتصر هذا التحيز على التجارب الفردية. فالشركات تميل لخلق ثقافات تتمركز حول معتقداتها الخاصة، ولغتها، ونهجها، ومنتجاتها. وخضوعًا لهذا القهر الثقافي، يضطر الموظفون – رغمًا عنهم – إلى قبول الأفكار المصنعة والمطورة ”داخليًا“ – أي داخل الشركة – على أنها أفضل وأكثر نفعًا من نظيراتها المصنعة لدى المنافسين. ومن ثم، فإن نفس النزعة تجاه منتجاتنا وإبداعاتنا الخاصة تتكرر تجاه أفكارنا أيضًا. فلأنك مبدع الفكرة، ينشأ بداخلك ذلك الاقتناع الفطري بأنها أهم من أفكار الآخرين، وهذا ما يعرف بعقلية ”صنع بالخارج“! وكغيرها من مظاهر طبيعتنا المثيرة للجدل، فإن هذا الهاجس الداخلي للمبالغة في التقييم هو سلاح ذو حدين. وعليك هنا أن تستفيد من هذا الميل الغريزي للاهتمام بأفكارك، وأن تحاول التخلص من تحيزاتك قدر الإمكان.
– سر بحثنا عن العدالة ..
السعي للانتقام غريزة بشرية تحقق لنا شعورًا بالسعادة والراحة، وهو من أكثر الغرائز المتأصلة في النفس البشرية. فكم من الدماء أُريقت وكم من الأرواح أهدرت في مذابح بشرية على مر التاريخ حتى وإن لم يغير ذلك من الواقع شيئًا! ورغم ذلك، ورغم كل الأضرار التي يجلبها الانتقام، فثمة وجهة نظر معارضة ترى أن الخوف من الانتقام يعمل كآلية فعالة تعزز النظام والتكاتف الاجتماعي.
تخيل – مثلاً – أننا كنا نعيش منذ ألفي عام في أرض قاحلة ومقفرة، وأنا أمتلك حمارًا تود أنت سرقته. فإذا كنت تدرك أنني إنسان عقلاني فسوف تخاطب نفسك قائلاً: ”لقد عَمِل وتعب لمدة عشرة أيام في حفر الآبار كي يتمكن من شراء الحمار، فإذا سرقته
وهربت إلى مكان ناء، فسيجد أن الأمر لا يستحق عناء البحث عن الحمار ومطاردة سارقه، وسيفضل حفر المزيد من الآبار ليشتري حمارًا آخر.“ ولأنك تعلم أنني لست على هذا القدر من الحكمة والعقلانية وأميل بطبعي إلى العنف والانتقام لدرجة قد تحدوني إلى مطاردتك حتى آخر العالم، فهل ستغامر وتقدم على سرقة حماري؟ بالطبع لا. فرغم رفضي لمبدأ ”العين بالعين والسن بالسن“، إلا أن الخوف من الانتقام أثبت فعاليته في إدارة العلاقات في المجتمعات.
حذرنا الحكماء من الفوائد – المزعومة – للانتقام. فقد قال ”ألبرت شويتزر“: ”الانتقام كالحجر المتدحرج الذي تصل به إلى قمة الجبل، فيرتد عليك بأضعاف القوة والعنف ويهشم عظامك التي دفعته إلى أعلى.“ ورغم هذه النصيحة التي تحذرنا من الانتقام، إلا أنه أمر يصعب تجنبه. فهو أمر مبني في الأساس على ثقتنا في الآخرين. وهناك الكثير من قصص النجاح التي كان الانتقام هو الوقود والدافع الرئيس لها. وعادة ما تشمل هذه القصص روادًا ومبتكرين ورجال أعمال. فعندما يطردون من مناصبهم كرؤساء تنفيذيين ومديرين، تبدأ عملية ”الانتقام“ في تغيير مسار حياتهم. فتارة ينجحون في استعادة مناصبهم السابقة، وتارة أخرى يعمدون إلى تأسيس أكبر منافس لشركتهم السابقة. فبعد أن طُرد ”جيفري كاتزنبرج“ من شركة ”والت ديزني“، لم يحصل على تعويض مالي قدره 280 مليون دولار فقط، بل أسس شركة ”دريم ووركس“ التي أنتجت فيلم ”شريك“ الذي حقق نجاحًا مبهرًا فأصبحت ”دريم ووركس“ من أخطر المنافسين لشركة ”والت ديزني“. الطريف في الأمر أن هذا الفيلم لم يقتصر على التهكم من روايات ديزني الخرافية، بل يقال إن شخصية الوغد في الفيلم هي تمثيل سلبي لشخصية ”مايكل إيسنر“ رئيس ديزني.
– لم نعتاد على بعض الأشياء ولكن ليس دائما ؟
التكيف أحد أهم العناصر التي تساعدنا على التفاعل مع المستجدات وتوجيه انتباهنا إلى المتغيرات، وهو بالتالي منبع للفرص الجديدة والمخاطر أحيانًا. يتيح لنا التكيف فرصة للاختيار بين ملايين المتغيرات التي تدور حولنا طوال الوقت فننتقى المهم منها
ونتغاضى عن غيرها. فإذا ظلت رائحة الهواء ثابتة دون تغير لمدة خمس ساعات متواصلة، فلن تشعر بها. أما إذا بدأت رائحة الغاز تتسرب إلى أنفك، فستلحظها في الحال، وتهرع خارجًا من المنزل وتتصل بشركة الغاز. فجسم الإنسان – لحسن الحظ – عبقري في القدرة على التكيف في كافة الظروف والمستويات.
التكيف ”الشعوري“ أهم أنواع التكيف. وهو يرتبط بردود أفعالنا تجاه التجارب السارة والمريرة معًا. تخيل هذه التجربة: أغلق عينيك لوهلة وتصور ما سيحدث إذا تعرضت لحادث مرير تسبب في عجز نصفك السفلي. سترى نفسك جالسًا في كرسي للمقعدين، وغير قادر على السير أو الجري مرة أخرى. ستتخيل المتاعب اليومية التي ستواجهك، وستشعر بالعجز وعدم القدرة على استئناف أنشطتك اليومية التي تسبب لك السعادة. سترى أبواب المستقبل قد أغلقت في وجهك ولن تفتح أبدًا.
تخيُل مثل هذه التجربة سيشعرك أن فقدان قدميك سيحول حياتك إلى جحيم.. وإلى الأبد! ورغم قدرة الإنسان على تخيل المستقبل وتوقعه، إلا أنه يقف عاجزًا أمام كيفية وآلية التكيف معه. فمن الصعب أن تتوقع التكيف مع كافة متغيرات حياتك، أو التأقلم مع إصابة دائمة، آملاً أن كل شيء سيكون على ما يرام. والأصعب أن تتخيل اكتشاف متع جديدة وغير متوقعة في ظل هذه الظروف الطارئة.
فقد ثبت أنه على الرغم من أن للإنسان قدرة مذهلة على التكيف السريع مع كافة المتغيرات أسرع مما يتوقع؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يحدث التكيف؟ وما مقدار تأثيره على قناعتنا؟
– التكيف والألم ..
قرر ”حنان فرانك“ – البروفيسور الذي التحق بالجيش وتعرض لبتر في القدمين – أن يجري تجربة على ما يمكن أن يعلمه لنا الألم عن التكيف. اقتصرت التجربة على من تعرضوا لإصابات في الجيش. وعندما جاء المشاركون، استقبل كلاً منهم بإناء من المياه الساخنة ملحق بمولد حراري ومقياس حرارة. قام ”فرانك“ بتسخين المياه إلى درجة 48 مئوية، وطلب من كل متسابق أن يضع ذراعًا واحدة فيها.
بدأ في تشغيل ساعة توقف وطلب من كل متسابق أن يخبره على الفور باللحظة التي تبدأ فيها الحرارة بالتحول إلى شعور بالألم لم يعد المتسابق قادرًا على تحمله. ثم أجرى نفس التجربة على الذراع الأخرى. بعد ذلك قسم المتسابقين إلى مجموعتين وفقًا لشدة الإصابة. وجد أن الجنود ذوي الإصابات البسيطة بدؤوا في الشعور بالألم بعد 4.5 ثانية، بينما شعر ذوو الإصابات البالغة بالألم بعد 10 ثوان. الغريب في الأمر أن المجموعة الأولى بدأت في سحب أيديها من المياه الساخنة بعد 27 ثانية، بينما استمرت المجموعة الأخرى 58 ثانية!
توصل ”فرانك“ بعد هذه التجربة إلى أن هناك قدرة عامة على التكيف وهي جزء لا يتجزأ من القدرة على التكيف مع الألم. فعلى الرغم من مضي عدة سنوات على تعرض الجنود للإصابة، إلا أن قدرتهم على التكيف مع الألم وتحمله قد تغيرت وتفاوتت واستمر هذا التفاوت لسنوات طويلة.
– التعاطف والعاطفة ..
أليس غريبًا أن يبادر الإنسان إلى مد يد العون لشخص واحد فقط يحتاج للمساعدة، لا إلى مجموعة ممن هم في أمس الحاجة إليها؟! يتسم هذا السلوك بالتعقيد وطالما احتار فيه الفلاسفة والعلماء. فهناك العديد من القوى والعوامل التي تؤدي إلى شيء من ”اللامبالاة“ تجاه المآسي والحوادث الكبرى. ولكن تعتصر قلوبنا ألمًا ونتعاطف مع طفلة صغيرة تعرضت لحادث مؤلم بشكل أقوى وأسرع مما نشعر به تجاه ضحايا الدمار الشامل والمجاعات؟! ولماذا نفزع من أماكننا ونكتب الشيكات ونقدم التبرعات لشخص واحد بحاجة للمساعدة، ولا نشعر بمثل هذا الحماس تجاه المآسي الأكثر وحشية والتي تشمل الآلاف من الضحايا؟! وقد لخص ”ستالين“ هذه المسألة بدقة حين قال: ”يعتبر قتل شخص واحد مأساة وحشية، ويعتبر مصرع الملايين مجرد رقم واحد في إحصائية!“ لكي نفهم أكثر هذه النزعة العجيبة تجاه الفرد الواحد، أجرى كل من ”ديبورا سمال“ و”جورج وينشتاين“ و”بول سلوفيك“ تجربة خاصة بهذه الظاهرة. مُنح كل مشارك 5 دولارات ومنشور يتضمن بعض المعلومات عن مشكلة تتعلق بنقص الغذاء، وطلب من كل منهم أن يتبرع بقدر من المال لمواجهة الأزمة. تضمن منشور المجموعة الأولى – وهي مجموعة القياس – خبرًا يقول: ”ثلاثة ملايين طفل في ملاوي يعانون من الجوع ونقص الغذاء. وفي زامبيا تسبب النقص الحاد في الأمطار والمياه في جفاف محصول الذرة عام 2000 . وبالتالي يعاني أكثر من ثلاثة ملايين شخص من المجاعات.“ أما المجموعة الثانية فقد قرأت هذا الخبر: ”رقية طفلة بائسة تبلغ من العمر سبع سنوات وتكاد تموت من الجوع في مالي.“ نظر المشاركون إلى صورة رقية بإشفاق وهم يقرؤون: ”ربما يساعد تبرعك في تغيير حياة هذه الطفلة البائسة. تبرعك سيوفر لها الطعام والتعليم والرعاية الطبية اللازمة.“ العجيب في الأمر أن نسبة التبرعات لمجاعات الجماعات في ملاوي وزامبيا لم تتجاوز 23 ٪ من أموال المتبرعين. أما التبرعات للطفلة ”رقية“ فقد زادت ! عن الضعف ووصلت إلى 48٪ هذا هو ما يطلق عليه علماء الاجتماع ”تأثير الضحية المعروفة“. فبمجرد أن تحصل على صورة (وجه) وبعض التفاصيل عن شخص ما، تتعاطف معه بشدة وتساعده بكل شيء، وحتى بالمال. أما إذا كانت المعلومات عامة وتشمل جماعات، فينخفض مستوى التعاطف، ولا نتفاعل بقوة مع الموقف.
– لماذا يجب أن نتفاعل مع المشاعر السلبية ؟
تتسم المشاعر بصفة عامة بالتقلب والتغير السريع شئت أم أبيت. فقد تنزعج من التكدس المروري، وتسعد بهدية من صديق، لكن هذه المشاعر لن تدوم طويلاً. ردود الأفعال السريعة والمفاجئة تجاه تلك المشاعر غير محبذة؛ حتى لا تنجم عنها قرارات وسلوكيات خاطئة تندم عليها طوال حياتك. فعندما ترسل لمديرك رسالة بريد إلكتروني تعبر فيها عن غضبك تجاهه، أو تجرح شخصًا قريب إليك، أو تشتري ما لا يمكنك تحمل نفقاته، فستندم على ما فعلت بعد أن تخف وطأة الشعور بالغضب أو بالرغبة الملحة للشراء. لهذا السبب عليك أن ”تعد إلى عشرة“ و”تنتظر حتى تهدأ“ قبل أن تتخذ قراراتك.
تتبخر المشاعر بصفة عامة – أيًا كانت قوتها – مع مرور الوقت ودون رجعة. افرض أن أحدهم قطع عليك الطريق في أثناء ذهابك إلى العمل. ستغضب قليلاً، وتأخذ نفسًا عميقًا، وتستأنف رحلتك. ثم ستستعيد تركيزك في الطريق وفي الأغنية التي تستمع إليها.
في مثل هذه الحالات فقط، لا تتأثر قراراتك سلبًا بهذا الغضب قصير الأجل. وقد أراد ”إدواردو أندريد“ – الأستاذ في جامعة ”كاليفورنيا“ – أن يتأكد مما إذا كانت هذه المشاعر تؤثر على قراراتنا في المدى البعيد. وقد بنى نظريته على التجربة التالية: تخيل أنك تعرضت لأمر ما جعلك في غاية السعادة والكرم، كأن يكسب فريقك المفضل المباراة على سبيل المثال. وقد دُعيت في هذا المساء لتناول العشاء في منزل خالتك، فقررت أن تشتري لها باقة من الزهور تحت تأثير هذا الشعور السار. بعد مرور شهر – وبعد أن ذابت تلك المشاعر الجميلة – جاء موعد الزيارة الثانية لمنزل خالتك. ولسوف تفكر فيما يمكن أن تفعله لكي تبدو ابن أخت صالحًا، وستستعين بذاكرتك لتتذكر الهدية الرقيقة التي قدمتها لها في المرة السابقة وكيف كان تأثير ذلك عليها، فتقرر أن تكررها. وستظل تكرر سلوكك مرة بعد أخرى حتى يصبح عادة مستديمة وتلقائية. فعلى الرغم من انتهاء السبب الحقيقي وراء هذا التصرف – فرحة الانتصار في المباراة – فإنك تتأثر به كمحفز لما يجب أن تفعله لاحقًا. وهكذا يمتد
تأثير المشاعر والانطباعات الأولى ليشمل كثيرًا من القرارات المستقبلية.
– لعبة الإنذار الأخير ..
ليختبر فكرة تتابع المشاعر، بدأ ”إدواردو“ بالتحضير لثلاث خطوات رئيسة: أولها أن يتسبب في إغضاب أو إسعاد المتسابقين. تقودنا هذه المشاعر المؤقتة إلى الخطوة التالية من التجربة التي يتخذ فيها المتسابقون بعض القرارات تحت تأثير هذا الشعور الانفعالي.
ثم ينتظر حتى تخمد مشاعرهم ليتخذوا مزيدًا من القرارات، ويتأكد ما إذا كان لمشاعرهم الأولية تأثير طويل الأجل على خياراتهم اللاحقة.
تتكون لعبة الإنذار الأخير من متسابقين: مرسل ومستقبل. يجلس كل منهما على حدة دون أن يعرف هوية الآخر. تبدأ اللعبة حين يمنح المختبِر المرسل مبلغًا ماليًا وعليه أن يقرر كيف سيتقاسمه مع المستقبل. وبعد أن يقرر، تكون للمستقبل حرية التصرف في أن يقبل أو يرفض هذا العرض. في حال قبول العرض، يأخذ كل منهما النسبة التي حددها المرسل، وفي حالة الرفض لا يحصل أي منهما على شيء ويعود المال إلى المختبِر.
تم تقسيم المتسابقين إلى مجموعتين؛ الأولى تبدأ التجربة بمشاهدة فيلم مثير لمشاعر الحنق والغضب. بينما بدأت المجموعة الثانية بمشاهدة مقطع من المسلسل الكوميدي ”فريندز“، وطُلب من المجموعتين أن يكتبوا عن تجربة مماثلة لتلك التي شاهدوها للتو. بدأت اللعبة بعد ذلك واتخذ كل من الفريقين قراراته. وُجد أن المجموعة الأولى التي سيطرت عليها مشاعر الغضب كانت أكثر ميلاً لرفض العروض غير العادلة. فالإنسان يميل بطبعة